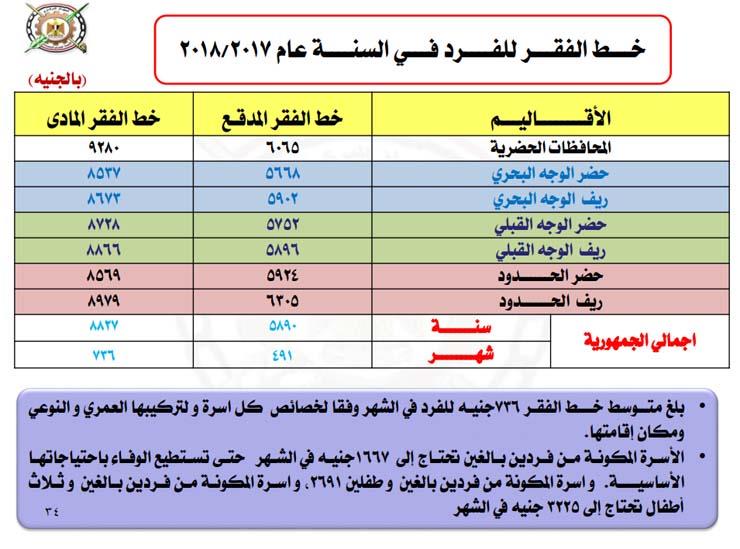الحفاظ على الأطفال ضحايا الخلافات الأسرية أو الطلاق. وتتكفل اللجنة برعاية الأطفال ماديا ونفسيا ومعنويا إلى حين حل المشكلة أو إيداعهم بإحدى المؤسسات الاجتماعية التابعة للحكومة.
إرشاد أسري إلزامية قبيل إبرام العقود الرسمية على أيدي المأذونين كنوع من التوعية بطريقة تكوين أسرة ووقف الجهل بالحقوق والواجبات لكل طرف في العلاقة بشكل يحول دون ارتفاع معدلات الطلاق وتشريد الأبناء بعد الانفصال.
اللجنة العليا للإرشاد الأسري في كل إقليم بينهم رجال دين من الأزهر والكنيسة ومتخصصون في القضايا الأسرية والنفسية والاجتماعية والإنجابية لتثقيف كل طرف بخطوات الارتباط وتكوين عائلة مستقرة والتعريف بالمفاهيم الصحيحة للزواج والمسؤوليات.
“تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
عقد أكثر من جلسة معهما ومع المقربين منهما لمنع وصول الأزمة إلى الانفصال عبر متخصصين نفسيين وأسريين واجتماعيين حيث يكون الطلاق الخيار الأخير.
من مرحلة العزوبية إلى العائلية دون خبرات كافية حول شكل وطريقة تكوين أسرة مستقرة خالية من المنغصات، وأي خطوة تثقيفية قبل الزواج كفيلة بخفض النزاعات الأسرية وتقليل الطلاق بشكل نسبي.
المعضلة تكمن في اختزال المشورة الزوجية في الحلال والحرام، وما بجب فعله وتجنبه لعدم مخالفة التعاليم الإسلامية وهي دورات توعوية منقوصة لأنها لا تتطرق إلى المفاهيم الأساسية للزوا،ج والحفاظ على الكيان الأسري بعيدا عن الدين. الازهر وكذلك الكنيسة
تعريفهم بشكل العلاقة بعد الارتباط الرسمي يخفف من وطأة التغيير الجذري الذي يحدث في حياتهم بعد الانفصال عن الحياة العائلية لمرحلة تكوين أسرة خاصة بكل طرف، وهذه مرحلة صعبة على كليهما تتطلب وعيا وإدراكا بكيفية إدارة العلاقة مع الشريك بهدوء.
انتقال أي شاب وفتاة من مرحلة المراهقة إلى المسؤولية دون فهم ووعي لما سوف يقابله من مسؤوليات ومشكلات يتسبب في الكثير من الأزمات التي قد يخفق كلاهما في حلها بسهولة، وهنا تأتي ميزة التثقيف والتوعية بمتطلبات الحياة الزوجية في كل التخصصات لرسم المستقبل أمامهم قبل الانخراط فيه بجهل ما يجعل الزوجين يعيشان حياة ملغمة بالصراعات.
ميزة إدراج المتخصصين النفسيين والأسريين في لجان الإرشاد الأسري أن الدورات التأهيلية التي سيتم تقديمها للشباب والفتيات ستكون متحررة فكريا وثقافيا واجتماعيا، بعيدا عن المحرمات الاجتماعية والأسرية حول العلاقة الحميمية والثقافة الجنسية التي يجهلها أغلب المقبلين على الارتباط وانحسار الأفكار الحالية في التكاثر وزيادة الإنجاب والإثارة.
تجبر إلزامية الدورات التأهيلية في حد ذاتها الشريحة التي يمكن أن تعزف عن خوضها لأسباب ترتبط بالعادات والتقاليد والمحرمات، وبالتالي فإن الإجبار سوف يشمل إجراء الفحوصات الطبية والتأهيل النفسي والطبي والسلوكي، ما يمهد الطريق لاختراق الثقافات المتحجرة في المناطق الريفية والشعبية حول العلاقة الزوجية واختزالها في الجنس فقط.
الميزة المهمة أيضا لمشروع القانون أن لجنة الإرشاد الأسري ستكون مسؤولة عن حماية الأطفال ضحايا الخلافات الأسرية أو الطلاق، حيث يتم رعايتهم ماديا ونفسيا ومعنويا إلى حين حل المشكلة أو إيداعهم بإحدى المؤسسات الاجتماعية التابعة للحكومة تمهيدا لتسليمهم لمن له حق حضانتهم بعد الطلاق بعيدا عن اللجوء إلى المحاكم لحل هذه المشكلة، حيث لا يكون الأطفال الحلقة الأضعف في الصراع الأسري.
*Aug 8, 2021
البرلمان يناقش تشريعا لحصول المرأة على جزء من أملاك طليقها لإعانتها.
فالرجل لم يطلقها وحدها، بل طلقها وأولادها، لتعيش حياة خالية من مقومات السعادة، والكثير من المطلقات لا يجدن الحد الأدنى من الموارد للإنفاق على أنفسهن وأولادهن.
مؤيدون للقانون أنه من الطبيعي أن تحصل المطلقة على جزء من ثروة زوجها باعتبارها ساعدته كثيرا في تربية أولادها أو إنهاكها في المنزل، وعدم إرهاقه في أيّ شيء ليركز جهده في تكوين هذه الثروة، أيا كان نوعها وقيمتها، لأنه بدون مساندة زوجته له لم يكن ليستطيع وحده أن ينجح أو تكون لديه مقدرة مادية.
انعكاسات سلبية على العلاقة الزوجية التي يفترض أن تكون قائمة على المشاركة والتفاهم، فليست كل النساء بصفات ملائكية وقد تكون بينهن من تستغل مثل هذه التشريعات لقهر الرجل وابتزازه ماديا.
فكرة اقتسام الثروة غير منطقية. فقد تلجأ أيّ امرأة إلى طلب الطلاق لتحصل على المال ثم تتزوج من آخر.
الحد من الطلاق لا يكون بإصدار تشريعات قد تكون محفزة على انهيار العلاقة من جانب بعض السيدات أو محبطة للمقبلين على الزواج، فكل من لديه مقدرة مالية، ربما يخشى الإقدام على هذه الخطوة، خشية سوء اختيار شريكته، ويتم الطلاق، وتقاسمه في ثروته.
يعتقد متخصصون في العلاقات الأسرية أن القضاء على المشكلات التي تواجه المطلقة لا يكون بتشريعات تفتح بابا واسعا للاستغلال والانتهازية بين الزوجين، والتهديد بإمكانية طلب الطلاق في أي وقت للحصول على جزء من الثروة، بل بتطوير منظومة المحاكم التي تفصل في قضايا النزاعات الأسرية لا تأجيلها لسنوات، لتظل المطلقة تتسول المال.
هناك مطلقات لا يستطعن إثبات الدخل الشهري الثابت للرجل ليحدد القاضي قيمة النفقة، وأخريات يفشلن في الحصول على مستندات تخص ممتلكات الزوج لتقديمها إلى المحكمة، حتى أن بعض الرجال يقدمون شهادات تثبت عدم قدرتهم المادية على دفع النفقة، ويحصلون عليها بطرق ملتوية لقهر المطلقة وإذلالها والانتقام منها.
إقرار قانون يعطي للمرأة الحق في الحصول على جزء أو نصف ممتلكات الرجل حال الطلاق قد يقود إلى ارتفاع ظاهرة الهجر الزوجي، أو ما يعرف بترك المرأة معلقة، لا هي متزوجة ولا مطلقة، كنوع من إجبارها على طلب الطلاق والتنازل عن كامل حقوقها لتنال حريتها، أو تضطر لرفع دعوى خلع لتخسر كل شيء.